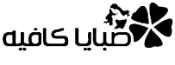العلم ..مفتاح للإعجاز!
يختلف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن غيره من أنواع الإعجاز القرآني، ولا يصدر هذا الاختلاف من كون هذا النوع من الإعجاز أكثر أهمية من غيره - كما يُروَّج لذلك أحياناً - إذ إن القرآن معجز من كل وجه وفي كل جانب من جوانبه، ويشهد بذلك جموع المسلمين الذين دخلوا - ولازالوا يدخلون - هذا الدين على مَرِّ العصور انجذاباً إلى الجوانب الروحية والإنسانية التي يزخر بها القرآن الكريم.
لكن الذي يميز الإعجاز العلمي عن غيره من أنواع الإعجاز هو مصداقية العلم التي تكاد أن تكون مطلقة في نظر البعض، مقارنة مع غيره من مجالات المعرفة البشرية، فقد حظي العلم بمرتبة متميزة في عصرنا هذا وضعته في قمة الهرم المعرفي، وأسبغت عليه ثوب المرجعية فيما هو صحيح وما هو خطأ. ومن هنا فإن موضوع الإعجاز العلمي يتميز عن غيره من مواضيع الإعجاز القرآني في كونه مضطراً إلى التعامل مع هذه المرجعية التي أصبحت جزءً واقعياً ملموساً في حياة المسلمين وغيرهم شئنا ذلك أم أبيناه. وفي مقابل ذلك فإن أنواع الإعجاز القرآني الأخرى مثل الإعجاز البياني أو التشريعي في القرآن الكريم لا تواجه مثل هذه المرجعية نظراً لأن مسألة تذوق البلاغة القرآنية مثلاً يتفاوت في إدراكها الناس. فكما أننا لا يمكن أن نتوقع من جميع الناس إدراك الإعجاز البياني للقرآن الكريم نظراً لتفاوت قدراتهم اللغوية، فإنه لا يمكن لأحد أيضاً أن ينكر وجود هذا الإعجاز ثم يكون إنكاره هذا أكثر من رأي شخصي للمنكر، ويرتبط هذا الأمر بطبيعة موضوع الإعجاز هنا، وهو البلاغة أو التشريع، وهما موضوعان لا توجد لهما مرجعية إنسانية مطلقة تحكم بما هو صواب وما هو خطأ، بل هما محل اختلاف الناس من قديم؛ بسبب الأذواق والأفهام والتي إما أن تكون نقية سليمة فتقود صاحبها إلى الإيمان، وإما أن تهيمن عليها الأهواء فتحيد بصاحبها عن الفطرة السوية وتحجبه عن قبول الحق.
أما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فيختلف عن غيره من أنواع الإعجاز القرآني من حيث المرجعية "المطلقة والموثوقة" التي يحظى بها العلم، وخصوصاً في العالم الغربي كما أشرنا إلى ذلك آنفا. ولقد حاول البعض من المتدينين والمطلعين على الثقافة العلمية الحديثة - بعد أن لمسوا الإشارات القرآنية الكثيرة للأمور الكونية - الاستفادة من "مرجعية" العلم وانبهار الناس به مسلمهم وكافرهم لإثبات صدق الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم. لكنهم في سعيهم لهذا الإثبات استخدموا سلاحاً ذا حدين، إذ إنهم كرسوا مرجعية العلم وأقروا بها دون مراجعة أو تدقيق، فجعلوا النصوص الشرعية – وعلى غير قصد منهم- في موقف المتهم حتى يثبت العلم براءتها! فظهرت تأويلات غير ضرورية لنصوص شرعية ثابتة؛ بحجة أنها تخالف الحقائق العلمية المقررة والأمر أبعد ما يكون عن ذلك!
ومن أجل هذا المزلق الخطير كان لابد من وقفة متأنية لدراسة هذه الظاهرة - ظاهرة الاستدلال بالمعرفة العلمية لإثبات صدق النصوص الشرعية متمثلة في الكتاب والسنة - ومعالجتها من الناحية العلمية والناحية الشرعية على حد سواء. ولا أزعم أن مثل هذه المقالة يمكنها أن تفي بجميع جوانب الموضوع، ولكن حسبنا أن نشير فيها إلى بعض الإشارت على طريق المعالجة الموضوعية المنشودة، وذلك بالحديث عن شيء من طبيعة المعرفة العلمية ومكانتها بين الظن واليقين، وكيفية توظيف هذه المعرفة في مسألة الإعجاز العلمي آملين أن يسهم هذا المقال في إعادة نظر المهتمين بقضية الإعجاز العلمي في نواحيها المختلفة وتقويم مسيرتها حتى تؤتي ثمارها المرجوة بإذن الله تعالى.
ماهو العلم؟
لعله مما لا يستغرب عدم وجود تعريفٍ دقيقٍ مجمعٍ عليه للعلم وللمعرفة التي يقدمها، فبالرغم من تميز المعرفة العلمية بالدقة والتحديد على وجه العموم إلا أن دراسة طبيعة هذه المعرفة ليس مما يشتغل به العلماء الكونييون، بل هو من تخصص فلاسفة العلوم، والذين تتفاوت آراؤهم تفاوتاً كبيراً تبعاً للمدرسة التي ينتمون إليها في التفكير، ويشرح لنا غريغوري ديري [[1]] في كتابه " ما هو العلم وكيف يعمل" صعوبة تعريف العلم لكنه يشير إلى أن أي تعريف للعلم لا بد وأن يتضمن شيئاً عن "الطريقة العلمية" أي الطريقة التي يتم التوصل بها إلى المعلومة العلمية والتي من عناصرها الفرضية العلمية، والتجربة، والاستنتاج المبني على المشاهدة، وقابلية الحصول على نفس النتيجة عند إعادة إجراء التجربة تحت الظروف المتشابهة، ومن جانب آخر فإن أي تعريف للعلم - والكلام لا يزال لديري- لابد وأن يتضمن أيضاً مجموع المعارف العلمية التي توصل إليها العلم عبر مسيرته الطويلة فالقوانين، والنظريات، والمباديء العلمية كلها تدخل فيما يسمى علماً. وكأن ديري يريد أن يقول إن قصر التعريف على المنهج العملي يجعله غير معبر عن المكانة التي يحتلها العلم بشكل صحيح فهذه المكانة التي احتلتها كلمة "علم" في قاموس اللغة إنما جاءت من تلك المعارف الهائلة التي تنسب إليه، وليس من مجرد الطريقة العلمية التي يتوصل بها إلى استنتاج المعرفة العلمية. ومما يؤيد ذلك ما ذهب إليه الفيزيائي الكبير ريتشارد فاينمان من إدخاله المنجزات العلمية بما فيها التكنولوجيا تحت مسمى العلم أيضاً [[2]]. ومن ناحية أخرى فإن المنهج العلمي للوصول إلى المعرفة العلمية ليس منهجاً واضح المعالم كما قد يتصور لأول وهلة، فالفرضية العلمية لا تسبق دائماً التجربة التي تُجرى لإثباتها، كما أن الاستنتاج قد يسبق التجربة المطلوبة لإثباته، وفي تاريخ العلم الكثير من الأمثلة التي تشهد بذلك. ويمكننا إذا أردنا الجمع بين الطريقة العلمية والمنجزات المعرفية للعلم في محاولة تعريفنا له أن نقول: "إن العلم هو مجموعة المعارف التي تم التوصل إليها عن طريق "استخدام المنهج العلمي" والذي يُعرَّف – بدوره - على أنه ذلك المنهج المؤسس على التجربة، والذي تحكمه الاستنتاجات المبنية على المنطق العقلي أوالنماذج الرياضية أوالطرق الإحصائية". وفي حين أن هذا التعريف يعتريه ما يعتري غيره من المحاولات الأخرى لتعريف العلم من نقص وغموض، إلا أنه يحتوي - في المجمل - على عناصر التعريفات المختلفة في كثير من المصادر التي تعنى بهذه القضية، مع ملاحظة أن الكثير من هذه المصادر تحاول أن تتحاشى تقديم تعريف محدد للعلم نظراً لصعوبة هذا الأمر.
هل يعبرالعلم عن الواقع؟
يميل أكثر المشتغلين بنقد المعرفة العلمية إلى المذهب الأداتي البرغماتي (النفعي) والذي يعد المعرفة العلمية مجرد أداة برغماتية للاستنباط والتنبؤ وليس خبراً عن الواقع [[3]]. ومما شجع هذا التيار على النمو والازدهار ما نتج من تناقضات منطقية في التجارب التي تختص بالعالم الذري والذي تحكمه الميكانيكا الكمومية؛ فقد اضطر العلماء إلى القبول بتصورات ومفارقات لا يوجد نظير لها في العالم الذي نشهده ونتعامل معه، مما حدا بفريق كبير منهم إلى اعتناق المذهب الأداتي الذي نتحدث عنه للخروج من مأزق التناقض المنطقي الذي تقترحه نتائج التجربة لو كانت تعبر بالفعل عن حقيقة العالم.
فعلى سبيل المثال يعتقد الأداتيون بأن "الكائنات" الدون ذرية مثل الإلكترونات والبروتنات والنيوترنات وما دونها لا تعبر بالضرورة عن وجود حقيقي مستقل بالشكل الذي نعهده عندما نتكلم عن وجود كرات البلياردو مثلاً، فنحن لم نر هذه "الكائنات" أصلاً، بل استنتجنا وجودها من عدد من التجارب التي أَمْلَتْ طبيعةً "جُسيميَّةً" لها، ثم أَملتْ تجاربُ أخرى أُجريت على هذه "الكائنات" - والتي أطلقنا عليها اسم جُسيمات - أملت هذه التجارب الأخرى طبيعة "موجيةً" لها. فكيف يكون الشيء جسيماً وموجةً في نفس الوقت؟ وما معنى وجود موجة من دون وجود وَسَط تتموَّج فيه؟ هل يمكننا أن نتصور وجود موجة البحر مثلاً دون وجود البحر نفسه؟ لكن العلم يُصرُّ على أن الكائنات الدون ذرية هي كائنات جسيمية وموجية فتارة تتصرف على أنها موجة وتارة تتصرف على أنها جسيم، والأغرب من ذلك أن كل جسيم من هذه الجسيمات لا يسمح لنا من التحقق من طبيعته الازدواجية (الموجية-الجسيمية) بشكل انفرادي ، فسرعان ما يتخلى عن طبيعته الموجية إذا ما حاولنا "الاقتراب" منه للتحقق منها. وبالرغم من كل هذه التناقضات التي تنطوي عليها الميكانيكا الكمومية فإنها قد أثبتت نجاحاً مذهلاً في التعامل مع العالم الدون ذري، ونشأ عن هذا النجاح كل ما نراه اليوم من تقدم تقني وتكنولوجي من صناعة الحاسب الآلي إلى غزو الفضاء.
وهذه المفارقة بين نجاح الميكانيكا الكمومية في توصيف تصرف الكائنات الدون ذرية من جهة، وبين التناقضات المنطقية التي تثيرها والتي لا تتفق مع فهمنا اليومي للعالم الذي نعيش فيه من جهة أخرى، قد أدت الى انقسام العلماء إزاءها إلى فريقين: فريق عزا هذه التناقضات إلى نقص في النظرية الكمومية مع إقراره بنجاحها منقطع النظير، ومن هؤلاء ألبرت أينشتين، ولويس دي بروي وديفد بوم، وفريق أنكر وجود حقيقة موضوعية أصلاً واعتبر أن العالم يوجد فقط عندما نتعامل معه وعُرِف هذه الاتجاه فيما بعد بـ"مدرسة كوبنهاغن"، والتي كان على رأسها نيلز بور وفيرنر هايزنبرغ. ولكن من الواضح أن موقف مدرسة كوبنهاغن موقف ميتافيزيقي، لا يدخل في نطاق البحث العلمي والذي ينحصر في العالم المادي، وبالتالي فإنه - وبالتعريف - لا يمكن لأتباع مدرسة كوبنهاغن أن يزعموا أن نتائج التجارب العلمية تقتضي موقفهم ذلك، ثم يزعموا "علميّة" هذا الموقف. والشيء الذي يجمع عليه الفريقان هو أن الميكانيكا الكمومية لا تعبر عما يحدث فعلاً إما لإنها ناقصة (رأي أينشتين ورفاقه) وإما لأنه لا يوجد شيء يحدث فعلاً في الخارج قبل عملية القياس التي نجريها (رأي مدرسة كوبنهاغن)، ومن هنا يبرز دور المدرسة الأداتية التي نتحدث عنها، إذ تمثل القدر المتفق عليه بين كلا الفريقين فالميكانيكا الكمومية بما تشتمل عليه من مصطلحات وتعبيرات هي عبارة عن أداة للتعامل مع الواقع فحسب، وربما كان هذا القدر المتفق عليه بين المدرستين سبباً في انتشار المذهب الأداتي في المعرفة العلمية، فاجتذب تأييد غالبية العلماء الكونيين وفلاسفة العلم على اختلافات بينهم في تفصيلات المذهب لا محل لذكرها في هذا المقام.
ويمكننا تشبيه القيمة الأداتية للعلم والخطأ الذي ينتج عن عدم فهمها، بما يحدث عندما ينظر أحدنا إلى شكل توضيحي يبين الدورة الدموية في الجسم، تأخذ الأوردة اللون الأزرق في هذا الشكل، بينما تأخذ الشرايين اللون الأحمر، فلو حاول أحدنا أن يأخذ الشكل التوضيحي على أنه يصوِّر الحقيقة فعلاً فسيظن أن لون الأوردة أزرق بالفعل، أو أن لون الدم الذي يجري فيها أزرق بالفعل... وهكذا يمكن أن نخطئ حينما نأخذ بعض التقريرات العلمية على أنها تصوير للواقع بينما تكون هي مجرد تمثيل له.
العلم بين ظاهر الأمور وحقائقها
الواقع أو الحقيقة من القضايا الميتافيزيقية، والتي لا تدخل تحت نطاق العلم أصلاً، وقد حذر الفيلسوف الفرنسي الوضعي أوجست كونت منذ القرن التاسع عشر من تعرض العلم لمحاولة إدراك حقيقة الأشياء فقال "إن أي نظرية علمية تدَّعي أن بإمكانها معرفة حقيقة الظاهرة تصبح قولا ميتافيزيقياً ينبغي رفضه تماما، لأن العلم لا يبحث في ماهية الأشياء، وإنما يكتفي بالوقوف عند حد الوصف الخارجي للظاهرة فما يهم العلم هو كيفية حدوث الظاهرة" [[4]].
فلا بد لنا أن ندرك حين نتحدث عن المعارف العلمية أنها إنما تتعلق بـ "ظواهر" الأشياء دون حقائقها، وهو أمر يُقرِّه كافة العلماء الكونين، فالبحث العلمي يسعى دائماً إلى واحد من أمرين:
1. وصف الظواهر الطبيعية، كما في علم الجغرافيا والتشريح مثلاً، فإن هذين الفرعين من المعرفة يهدفان إلى توصيف ما عليه الحال دون الدخول في كثير من الاستنتاجات، وقصارى ما يسهم العلم التجريبي في مجالهما هو إمدادهما بالأدوات العلمية المتطورة والتي تساعد في دقة الوصف وصحة التصنيف.
2. تفسير "الظواهر" الطبيعية، وذلك عن طريق إيجاد صيغ تفسيرية (مثل التصورات والمفاهيم العلمية كمفهوم الجاذبية والإلكترون مثلاً) أو قوانين رياضية للمشاهدات التي يلاحظها الباحث، ويندرج تحت هذا النوع علم الفيزياء والكيمياء وغيرهما، وقصارى ما يصبو إليه هذا النوع من العلوم هو إيجاد الصيغ التي تتفق مع المشاهدات وتتمكن من التنبؤ بمشاهدات أخرى عند تغير الظروف. أما الانشغال بالتأكد من مدى مطابقة هذه الصيغ التفسيرية للواقع والحقيقة من حيث هي لا من حيث نتائج المشاهدات التي اقترحتها في المقام الأول، فليس ذلك كله مما يعني العلم التجريبي من قريب ولا من بعيد.
فيمكننا أن نخلص مما سبق إلى أن هذين الصنفين من العلوم (ويشترك معهما في ذلك العلوم التي تجمع بين الوصف والتفسير كعلم الإحياء والعلوم الطبية مثلاً) لايُعنيان بدراسة "الحقائق" وإنما يعنيان فقط بدراسة "الظواهر"، ولعل مما يشير إلى أن العلم البشري - الذي يكتسبه الخلق بمعزل عن الوحي - إنما يتعلق بظواهر الأشياء لا بحقائقها هو قول الله تعالى : ".. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا".
وعلى ذلك فلا ينبغي إذاً أن نلهث وراء كل كشف علمي جديد، محاولين أن نثبت أن القرآن الكريم قد أشار إليه، كما لا ينبغي أن ننـزعج من عدم قدرتنا على ربط معلومة علمية - مهما بدت أهميتها في ميزان العلم - بآية أو أكثر من آيات القرآن الكريم، لأننا إن فعلنا ذلك نكون قد ألبسنا العلم ثوباً أوسع منه، وأعطينا معارفه المحدودة المتعلقة بظواهر الأمور فوق ما تستحق، فشتان بين الظاهرة المحدودة التي يعبر عنها العلم، والحقيقية المطلقة التي يقدمها القرآن.
وبالرغم مما ذكرنا فإنه لا ينبغي للمسلم أن ينكر أن يكون في هذا الكتاب العزيز إشارة إلى كل حقيقة أو ظاهرة في هذا الكون صغرت أم كبرت، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فإن النفي أصعب كثيراً من الإثبات، إذ يتطلب النفي الإحاطة الشاملة بجميع التفاصيل والمعاني المباشرة وغير المباشرة حتى يتمكن النافي من القول بأن القضية المذكورة لا توجد إشارة لها في القرآن الكريم ، ولا يجرؤ مسلم عاقل على القول بإحاطة عقله المحدود بكلام الله تعالى عز وجل فإن المحدود لا يحيط بغير المحدود "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب". وعلى ذلك يجب على المسلم الاحتياط والتأدب مع قوله تعالى : "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء "، كما يجب عليه عدم التسرع في إنكار ما يُعزى إلى القرآن الكريم من إشارت لبعض الأمور الكونية، إذ ما أدراه أنها ليست بإشارة... وإنما الذي يسوغ إنكاره من قبل أهل العلم والاختصاص هو وجه الاستدلال على أن آية ما تشير إلى ظاهرة بعينها وتتحدث عنها، وذلك من حيث دلالات اللغة ومعطيات العلم الحديث وخصوصاً حينما تُستخدم هذه الآية في إطار الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.
هل "الحقائق" العلمية قطعية ونهائية؟
لقد تعمدنا استخدام لفظ "حقائق" في عنوان هذه الفقرة بدلا من لفظ "نظريات" كما لم لم نلجأ إلى أي عبارة أخرى أقل تحديداً وأكثر حذراً مثل: "هل المحتوى المعرفي للنشاط العلمي قطعي ونهائي؟"، وذلك لهيمنة فكرة "المصداقية العلمية" على تفكير إنسان القرن الحادي والعشرين بشكل عام، مما أشاع عبارة "حقيقة علمية" في استخدامات الخاصة والعامة منا للتعبير عن أي معلومة تنسب إلى العلم، حتى لا تكاد عبارت مثل "نظرية علمية" أو "تفسير علمي" تُذكر إلا نادراً. ومن جانب آخر فإن قولنا "حقيقة" علمية يعني أنها كذلك في نظر العلم، ولا يعني بالضرورة أنها تمثل واقعاً حقيقاً موضوعياً يصف العالمَ، كما شرحنا ذلك عند الحديث عن المذهب الأداتي في تصور طبيعة المعرفة العلمية.
وفي عرضها لكتاب "ماوراء العلم" للفيزيائي الإنجليزي المرموق جون بولكين هورن تلخص د. يمنى الخولي وجهة نظره في المنجزات العلمية بأنها بالضرورة مؤقته وأن العلم " لا يُحرز حقائق يقينية قاطعة وقصارى ما يدعيه هو رجحان الصدق" [[5]]، وليس هذا النص بغريب، بل تكاد تجد أمثاله في كل كتابة جدِّية عن طبيعة المعرفة العملية، سواء كان كاتبها من فلاسفة العلم، أو من العلماء الكونيين في شتى التخصصات العلمية. ومع ذلك نجد أنه من الشائع لدى عامة الناس أن هناك حقائق علمية قطعية لن يتراجع عنها العلم أبداً، ومن الأمثلة الشائعة جداً، والتي يُستدل بها على هذا النوع من الحقائق: مسألة كروية الأرض، فكثيراً ما يعترض عليك المعترضون حين تتحدث عن عدم قطعية المعرفة العلمية بقولهم لقد أثبت العلم كروية الأرض فهل تعتقد أنه سيتراجع يوماً ما عن هذه "الحقيقة العلمية"؟
الحقائق العلمية بين الشهود والاستنتاج
والجواب عن ذلك أن هناك نوعان من الحقائق العلمية حقيقة علمية "مشهودة" وحقيقة علمية "مستنتجة". فالحقيقة العلمية المشهودة هي تلك التي رأيناها أو استشعرناها بحواسنا بشكل "مباشر" وذلك بمساعدة الوسائل العلمية الحديثة. ومثال ذلك تصنيف مراحل تطور الجنين الذي أثبته العلم الحديث من خلال تحديد شكل الجنين في مراحله الأولى والتي أطلق عليها القرآن الكريم أسماء: العلقة والمضغة، فكل هذه المراحل تمت رؤيتها بالعين المجردة، كما تم تصويرها وتوثيقها وتوصيفها في عصرنا هذا، بالاستعانة بالأدوات العلمية الحديثة. ومن أمثلة ذلك أيضاً ما نراه من صور التُقطت للكوكب الأرضي من زوايا مختلفة بواسطة الأقمار الصناعية، حيث تمثل الحقيقة العلمية المشهودة هنا كون الأرض كروية الشكل.
وربما أمكننا أن نتجاوز قيد "المباشرة" في تعريف الحقيقة العلمية المشهودة لندخل فيه ما أمكن رؤيته أو استشعاره بالحواس بشكل غير مباشر أيضاً أي بواسطة أدوات القياس العلمية الحديثة. وندرج تحت هذا الإطار جميع عمليات القياس العلمية وما يترتب عليها من مقارنات.
ونلاحظ من تعريفنا هذا للحقيقة العلمية المشهودة أن مصداقية هذه الحقيقة إنما تصدر من "شهودها" بواسطة حواسنا إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لا من "شهادة" العلم لها، وإنما يكمن دور العلم فقط في المساندة والمساعدة في الوصول إلى هذا الشهود. وهذا النوع من الحقائق العلمية قطعي لا يقبل التراجع عنه. وعلى ذلك فحقيقة "كروية الأرض" لا تستند في صحتها اليوم إلى أن العلم قد قال بها ولكن إلى شهودها بواسطة الصور والكاميرات الفضائية، فهي لا تصلح أن تستخدم مثالاً للتدليل على أن حقائق العلم قطعية بشكل عام.
أما النوع الآخر من الحقائق العلمية فهو الحقيقة العلمية المستنتجة، وهذا النوع خاضع وقابل للتغير في أي لحظة، إذ هو مجرد استنتاج يفسر نتائج التجربة، ولا ضمان على أنه نهائي لا يوجد استناج غيره أكمل وأدق منه، يمكن أن يظهر لنا في يوم من الأيام، كما أن هذا النوع من الحقائق العلمية قابل للانهيار في أي وقت تُظهر فيه التجربة نتيجة واحدة فقط لا يمكن تفسيرها بواسطته. وحيث إن الوقائع غير محصورة، فلا سبيل إلى التحقق من هذا النوع من الحقائق العلمية بشكل نهائي. وعلى ذلك تظل الحقيقة العلمية المستنتجة عرضة للنقض، مهما كثرت شواهدها وقل احتمال خطئها، ومن هنا فينبغي الحذر من استعمال هذا النوع من الحقائق العلمية في معرض التدليل على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإن كان من الممكن الاستئناس به في فهمهما ولكن دون مبالغة أو شطط.
ومثال الحقيقة العلمية المستنتجة مفهوم الجاذبية والذي يقول بأن الأجسام يجذب بعضها البعض، فهذا المفهوم ظل قرابة 3 قرون منذ أن اقترحه العالم الإنجليزي الشهير إسحق نيوتن وإلى أوائل القرن العشرين، ظل هذا المفهوم مع ما يصاحبه من قوانين فيزيائة، في محل تقديس من قبل العلم التجريبي والمشتغلين به، وفي منأىً عن أي شك أو ريبة، حتى سمي القانون المصاحب له بقانون الجاذبية ، إلى أن جاءت النظرية النسبية على يد ألبرت آينشتين لتستغني عن مفهوم الجاذبية وتصحح القوانين المصاحبة له بقوانين أخرى ومفهوم جديد (هو مفهوم انحناء الزمكان) ، في هزة عنيفة للوسط العلمي لم تكن تخطر على بال أحد، فكيف يمكن بعد ذلك اعتبار هذا النوع من "الحقيقة" العلمية قطعياً وكيف يمكن الاستدلال به في مسألة الإعجاز العلمي! علماً بأن مصطلح الجاذبية وقانونها لا يزالا يدرسان في مدراس وجامعات العالم على أنهما من حقائق العلم وذلك نظراً لسهولة استخدامهما مقارنة مع النظرية النسبية العامة.
ومن الأمثلة الأخرى التي يشاع أنها من الحقائق العلمية الثابتة - حتى لا يكاد أحد أن يجرؤ على إنكارها - مسألة دوران الأرض حول الشمس والتي بدأ بها عصر النهضة العلمية - كما يُسمّى - على يد كوبرنيكس في عام 1543 م، فهل تمثل هذه المقولة حقيقة تصف الواقع؟ أم أنها مجرد نموذج رياضي يسهِّل العمليات الحسابية التي نتمكن بها من رصد حركة الأجرام السماوية؟
هل تدور الأرض حول الشمس فعلاً؟
يجب أن نقرر أولاً أن مسألة دوران الأرض حول الشمس مما اتفق عليه العلماء الكونيين منذ قرون مضت غير أن هذا الاتفاق لا يعود إلى حقيقة مشاهدة أو واقع ملموس بل يرجع إلى دقة الحسابات الناشئة من افتراض أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. يقول الفيزيائي المعاصر بول ديفس:"واليوم لا يشك عالم في كون الشمس مركز المجموعة الشمسية وأن الأرض هي التي تدور وليس السماء" [[6]] ، ولكنه يستدرك قائلاً أنه لن نتمكن أبداً من التأكد من صحة هذا التصور مهما بدا دقيقاً "فليس لنا أن نستبعد كلياً أن صورة أكثر دقة قد تُكتشف في المستقبل" [[7]]، والحقيقة أننا لا نحتاج أن ننتظر اكتشاف تصور آخر لحركة النظام الشمسي حتى نتمكن من القول أن النظام الحالي والذي يفترض مركزية الشمس ودوران الأرض حولها هو مجرد افتراض رياضي لا يصور الحقيقة، بل إن العلم يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن السؤال عمّا إذا كان هذا التصور حقيقاً أو غير ذلك ليس بذي معنى في لغة العلم. فالحركة - والتي هي أسا