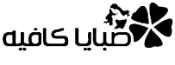تحذير من الانتشاء بظهور اللقاحات
في سباق ماراثوني محموم، محاط بصخب التنافس السياسي والتجاري وكثير من اللايقين العلمي، مضت كبرى شركات الأدوية العالمية في التبشير بقرب الوصول إلى لقاح مانع ماتع، ينهي جائحة كوفيدــ 19 بالقضاء على الفيروس المسبب لها سارس-كوف ـ2،
وأخيرًا، وبعد ما يقارب العام من الكرب والرجاء اللذين عمَّا سكان هذا الكوكب من البشر، تم الدفع بأكثر من لقاح تحت مظلة الضرورة الطارئة، لينتهي عام الكرب 2020 بكثير من الآمال، ويبدأ العام الجديد 2021 بشروق شمس أكثر من لقاح نال الاعتماد -المشمول بمظلة الضرورة الطارئة أيضًا
- من هيئات صحية في بلدان كبرى، وهيئات قارية، وبعض الدول الصغيرة الغنية، عمت البشرى سائر البشر، حتى هؤلاء المحرومين حتمًا من حظوتها، ومع بدء حملات التطعيم بهذه اللقاحات الموعودة، اجتاحت الكثيرين موجة كونية من النشوة بقرب القضاء على الفيروس "اللعين"، ووضْع نهاية لقصة جائحة بدا أنها القاضية، فهل انتهت هذه القصة؟
في الأدب، ترسَّخ القول بأن نهايات القصص تُشكل أهم ما فيها، إذ تضيء كل ما سبقها، وتصل بالسرد إلى "لحظة التنوير"، وهذا ينطبق على كل نشاط بشري، غالبًا،
والعِلم ليس استثناء، واللقاحات نموذج، فهل صحيح أننا وصلنا إلى بداية نهاية كوفيد-19، وحق للبشرية المحجورة المُكمَّمة -أو بعض هذه البشرية- أن تتحرر من الحجر والتكميم، وتنتشي؟ لن أجيب، بل سأترك الإجابات تتوارد من من مصادر قليلة أُتيحت أخيرًا،
مقارنةً بالسيل الجارف من مصادر التبشير بالخلاص المقرونة بالترويج للقاحات التي تم اعتمادها حتى لحظة كتابة هذه السطور؛ ففي لحظة معينة من مسيرة "الإنسان العاقل" على هذه الأرض، يصعب العثور على "الحقيقة العميقة" في خضم الضوضاء الصاخبة، ومن ثم يتوجب أن نصيخ السمع إلى الهمس النادر؛ لأنه أقرب إلى بوح الضمائر.
في مواجهة أعرق أمم الأرض
بداية أعترف أنني ممن يرون أننا مجرد أمة من أمم أخرى تسكن هذا الكوكب، صحيح أننا الأذكى عقلًا، والأقوى في قهر كثير من الأمم المختلفة على هذه الأرض، لكننا لسنا الأبرع في تكتيكات وإستراتيجيات البقاء وحكمة الاستدامة، على الأقل لأننا لم نراكم خبرات العيش التي تمتع بها غيرنا من الأمم الأقدم،
والأعرق، ومثالها أمة الفيروسات، فهي من أول التكوينات التي ظهرت على مسرح الحياة في كوكبنا منذ 3.8 مليارات سنة! وبرغم أن معظمها لا يتجاوز قطعة من جينوم في غلاف بروتيني، إلَّا أنها تفوقنا وتفوق غيرنا من وحوش البر والبحر قدرةً على العيش في أشد البيئات تطرفًا،
فهي موجودة حول الفوهات الحارة في قيعان المحيطات العميقة، وأسفل أغطية الثلوج القطبية، وفي السبخات الملحية، والبحيرات الحمضية، وهي في هذه البيئات القاسية، وغيرها المواتية، تشكل أكبر «أمة» من أمم الحياة في كوكبنا، تضم مئة مليون نوع، وتفوق عدد كل أشكال الحياة الأرضية مجتمعة،
وتعادل عشرة أضعاف أمة هائلة هي البكتيريا، ثم إنها ليست كلها مُمرِضة أو مُميتة، فالكثير منها أقرب إلى صون صحة الأرض وحياة سكانها، ويكفي للتذكير أن الفيروسات تمثل أكثر أشكال الحياة وفرةً في المحيطات التي تغطي 65% من سطح الكرة الأرضية، بمعدل 10 مليارات فيروس في كل لتر من مياه المحيطات!
وهذا الوجود الهائل مُكرَّس -ضمن مهمات عديدة- لحماية العوالق النباتية بمياه المحيطات من البكتيريا، فهذه العوالق تمثل قاعدة شبكة الطعام البحرية لكل ساكني هذه المياه، ومنها ما يقوم بعملية البناء الضوئي للحصول على طاقة استمراره في الحياة، مع إطلاق الأكسجين الذي يُشكِّل 50% من كل الأكسجين على كوكبنا،
الذي نتنفسه، ويتنفسه غيرنا، أما الفيروسات ملتهمة البكتريا داخلنا وخارجنا ومن حولنا، فلولاها لتحول كوكب الأرض إلى كوكب البكتيريا وكنا أول المنقرضين!
لكل ما سبق، ظلت تفجعني الخفة التي يتناول بها غلاة المتحكمين من البشر شأن فيروس سارس-كوف-2، أو كورونا المستجد المُسبِّب للجائحة التي تجتاحنا الآن، والذي ذهبت "النرجسية الخبيثة" -أي المضاف إليها كوكتيل من السادية والسيكوباتية والتدميرية البشرية وجنون العظمة- بأحد أشهر نماذجها في القمة،
إلى الدعوة إلى علاج المصابين بالفيروس بحقن المواد المطهرة التي تعقم بها أيادينا ومناضدنا وبلاط الحمامات والمرحاض! ولقد مكثت أستهجن وصف هذا الفيروس -هذا الكيان المدهش الذي تدب فيه الحياة ما إن يلوذ بخلية حية- بأنه "لعين" و"ماكر" و"قاتل"، بينما الحقيقة الأعمق أنه مخلوق أقصى غاياته،
كما هي غاية كل حي، أن يعيش ويستمر نسله في الحياة، وفي غيبة هذا الفهم، فشلنا فيما نجحت فيه كائنات "أدنى منا" وصلت إلى نوع من "العيش التكافلي" مع هذه الفيروسات، إذ "لا ضرر ولا ضِرار"، فهي لا تُمرض مضيفها، ومضيفها لا يبيدها، وأقرب وأوضح الأمثلة، هي الفيروسات التاجية التي سببت للبشر أوبئة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (سارس)، ثم كوفيدــ 19؛
فهي تتعايش تكافليًّا مع الخفافيش، ونتيجةً لتحرُّش البشر بالخفافيش، بممارسات رعديدة، عديدة، تضطر إلى الوثوب في "قفزة" إلى عائل جديد، الجِمال في ميرس، وقط الزباد في سارس، وما لم يتم تحديده حتى الآن في كوفيد-19، ونحن البشر، وخاصةً السفهاء منا،
مَن روَّع الخفافيش بقتلها بالمشاعل في سباتها بالكهوف، وتحريقها بدخان المشاعل في مهاجعها بالأماكن المهجورة، وباصطيادها وذبحها وطهي المرقة من أجنحتها، أما ما حدث من تغريق وتحريق لقط الزباد، لدرء انتشار سارس في الصين وغيرها، فهي بشاعة يصعب تصديقها على من لم يرَ وثائقها المصورة والمسجلة،
إذ كانوا يجمعونها في أقفاص سلكية ويغرقونها ثم يحرقونها ميتة، أو مُحتضرة، فمَن "اللعين" و"الغادر" و"القاتل"؟
الشمال تنتابه الهواجس
لكل ذلك، توقفت أمام مقال استقيت منه عنوان هذه السطور للكاتب الأمريكي تود إس بيروم، لأنه وبرغم أن كاتبه صحفي سياسي مثير للجدل، إلا أنه أحد القلائل الذين فتحوا بابًا للمسكوت عنه في صخب ظهور اللقاحات ونشوة التهليل لبزوغها،
ولم يكن الباب الذي فتحه انطباعيًّا ذاتيًّا، بل كان موضوعيًّا علميًّا، لأنه اعتمد فيما كتبه على آراء علماء ومشتغلين بالعلم، خاصةً فيما يتعلق باللقاحات البازغة ضد الفيروس المسبب لجائحة كوفيدــ19، وهذا ما يفسر إعادة نشر ذلك المقال في عشرات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد التقط أصوات الهمس العلمي،
برغم ضوضاء الصخب الذي حشر العلم في دهاليز وأنفاق ومخابئ ومغارات السياسة والتجارة وجنون العظمة، أو عقد النقص.
المقال تواتر نشره في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، تحت عنوان "احذروا من خطر نشوة اللقاحات" Beware the danger of ‘vaccine euphoria’، وفيه ما صرح به بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا، والذي وسَّع مهماته مؤخرًا ليشمل كوفيد-19 أيضًا، في نهاية العام المنصرم 2020 أمام المؤتمر الصحفي الذي استضافه "معهد ميلكن"،
وهو منظمة أمريكية مستقلة غير هادفة للربح معنية بنشر الأبحاث وإقامة المؤتمرات المعنية بقضايا الساعة، مؤكدًا أن "اللقاحات لن تكون متاحةً على نطاق واسع حتى أواخر العام 2021 على أقرب تقدير، وحتى هذا الحين ستستمر حياة كثيرين في الضياع بفعل هذا الفيروس"، وقد خلص "ساندز" إلى مفارقة صادمة تشير إلى أنه لن يكون أمامنا والأمر كذلك إلا "أن نستمر في غسل اليدين،
وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي"، أي عام كامل آخر يضاف إلى عام الكرب 2020، وقد زاد على ذلك وليام هولمان، عالِم النفس بجامعة "روتجرز" بنيوجرسي، والخبير في تصور المخاطر، قائلًا: "إن هناك خطرًا محتملًا من أن الناس الذين سيحصلون على اللقاح سيعتقدون أنهم صاروا محصَّنين،
وهذا غير صحيح، فاللقاحات لا تمنع العدوى بنسبة 100%، مما يجعل غير المُلقحين عرضةً للمرض، وإذا كان العاملون بالقطاع الصحي الذين يتم تطعيمهم -على الأغلب- سيتبعون إرشادات الصحة العامة فيواصلون ارتداء الأقنعة في عملهم كما في الأماكن العامة، فماذا عن غيرهم ممن يشكلون الأغلبية؟
خاصةً والأمر لا يتطلب فقط التوعية بطرق انتقال العدوى وخطورة الإصابة بها، بل بكيفية تغيير السلوك، وهذه مسألة نفسية واجتماعية لم يُدْعَ المختصون بتغيير السلوك للمشاركة فيها بالشكل الذي تستحقه".
أمر آخر، يُحجِّم فرط الحماس لظهور هذه اللقاحات، ويتعلق بالمدة التي سيستغرقها توزيع واسع وكافٍ لكل مَن يريده، فلا تزال هناك عوائق عديدة تحول دون الحصول الميسر والسريع على اللقاح من مختبرات الأدوية والمستودعات، بدءًا من تحديات الإنتاج الضخم، والشحن والتخزين والتوزيع،
وأوضح الأمثلة على تلك الصعوبات يشكلها لقاح شركة فايزر وشريكتها "بيو تك" الذي يتطلب التخزين في درجة حرارة منخفضة للغاية ( 70 درجة مئوية تحت الصفر)، ودرجة منخفضة أيضًا في لقاح مودرنا (20 درجة مئوية تحت الصفر)، وحتى لو تم تجاوز كل تلك العوائق ستظل هناك نسبة ممن لا يتلقون اللقاح من المنتمين إلى قناعة أو حركة "مناهضة اللقاحات"،
وهؤلاء سيضاف إليهم غير القادرين على تحمُّل اللقاح بسبب الحساسية أو ضعف المناعة، ومعهم بالضرورة مَن لم تتم دراسة تأثير اللقاح عليهم من أطفال وحوامل ومُرضعات، وعن هؤلاء قالت سامنثا بينتا، الأستاذة المساعدة في مواجهة الطوارئ بجامعة "ألباني- نيويورك": إن "مجرد ظهور اللقاح لا يعني أن نسبةً كافيةً من البلد محمية،
فالفيروس سيظل منتشرًا، وهناك مئات أو آلاف الخطوات الصغيرة المطلوبة والتي سيستغرق قطعها وقتًا طويلًا، شهورًا كثيرة مقبلة، ستبدو لكثير من الناس مشابهة تمامًا للأشهر التي أرهقتهم من قبل".
هذا عن عموم الناس، أما العاملون في القطاع الطبي، فتحدَّث منهم الدكتور روبرت مارشال، طبيب القلب بالعاصمة واشنطن، قائلًا: "بصفتي واحدًا من أخصائيي طب القلب التداخلي، علينا الاستمرار في افتراض احتمال إصابة كل مريض نتعامل معه بالعدوى، بغض النظر عما إذا كانت تظهر عليه أعراض أم لا،
وهذا حقيقي بشكل خاص مع ضحايا النوبات القلبية، لكونها نتيجةً معروفةً لدى المصابين بالفيروس المسبب لكوفيد-19، فعديد من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى إجراء فوري بينما لا يكون هناك وقت لإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالمرض، إذ لا يتوافر اختبار سريع قبل الاندفاع بالمريض إلى غرفة قسطرة القلب،
لذلك سنظل نرتدي معدَّات الحماية الكاملة، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية أولئك الذين نتعامل معهم، وقد يكونون أكثر عُرضةً للخطر، لن نغير هذا النهج في أي وقت قريب، ويجب عرض الحالة نفسها على الجمهور".
الجنوب في العالم الافتراضي!
كانت تلك معطيات ذلك المقال التحذيري من "مخاطر نشوة كورونا"، وهي على أهميتها تتوقف عند سطح الحقائق الإنتاجية واللوجيستية المُحبطة لوصول اللقاح بسرعة وشمول إلى جميع الناس في بلدان غنية ومتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا،
أما بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة -ناهيك بالدول الأشد فقرًا التي سقطت من ذاكرة العالم وضميره- يُمسي الأمر مثيرًا لضحك كالبكا، فذلك الضوء في نهاية النفق الذي يقول التحذير إنه أطول مما يتصور المتفائلون في الشمال والغرب، يُمسي طيفًا في حلمٍ مستحيل، فوسط السباق العالمي بين الدول المتقدمة لتأمين لقاحات كورونا لمواطنيها،
يُحذِّر الخبراء من إهمال الدول الفقيرة، مشيرين إلى ضرورة توفير لقاحات أخرى رخيصة الثمن ولا تتطلب درجات حرارة منخفضة جدًّا لحفظها، خاصة ومعظم البلدان الفقيرة يقع في نطاق المناطق الحارة، وقد أقلق ذلك "الائتلاف العالمي المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة"،
المدعوم من دول ومنظمات خيرية مثل مؤسسة جيتس إضافةً إلى مانحين أفراد، وقد خصص مبلغ 1,1 مليار دولار لتمويل تطوير تسعة لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا المستجد، وعبَّر عن هذا القلق الرجل الثاني في إدارة هذا الائتلاف فريدريك كريستنسن،
قائلًا: "إنني قلق للغاية؛ إذ انتشرت في أرجاء العالم صور تُظهِر سكان البلدان الغنية يتلقون التطعيم بينما لا يحدث شيء في البلدان النامية، وهذه مشكلة كبيرة جدًّا، وإذا كان قد تمّ التعهد بنحو ملياري جرعة من خلال "كوفاكس" وهي مبادرة ترعاها منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لكوفيد-19،
بهدف توفير فرص عادلة للحصول على اللقاحات، فإن العديد من الجرعات لا تزال افتراضية"، لننتبه: افتراضية!
شعب الممنوعين والممتنعين
وإذا كان حظ أهل الجنوب الفقير من هذه اللقاحات سيظل رهن "العالم الافتراضي" إلى حين ميسرة، ربما بعد أعوام أو عقود، فإن هناك فئةً ألقى بها قدرها المَرضي إلى "عالم الانتظار المفتوح"، وهم المصابون بضعف الجهاز المناعي ويكادون يشكِّلون بعددهم ومصابهم "شعبًا" موزعًا بين الأمم،
في الشمال كما في الجنوب، وينضوون تحت خمسة عناوين، هي:
1- الأمراض المزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وأمراض المناعة الذاتية كالذئبة والتهاب المفصل الروماتويدي، ومرض السكر من النوع الأول، ويضاف إليهم المصابون باللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية.
2- متناولو بعض العلاجات الطبية المُضعِفة للمناعة: كأدوية السرطان، والاستخدام طويل الأمد للكورتيكوستيرويدات، وبعض الأدوية المضادة للروماتيزم المناعي. 3
- حالات زرع الأعضاء أو نخاع العظام، المُحتّمة للاستمرار في تناول الأدوية المثبطة للجهاز المناعي لمنع رفض الزرعة.
4- المتقدمون في السن الذين لا يستجيب جهازهم المناعي بشكل طبيعي في مواجهة العدوى مثل الأشخاص الأصغر سنًّا
5- المدخنون الذين يؤثرون التدخين على قدرة جهازهم المناعي في الاستجابة المناسبة للأمراض، ومنها كوفيد-19،
فهو مرض تنفسي وقد لا يمتلك المدخنون أنسجةً رئويةً صحيةً كافيةً لمقاومة الفيروس.
كل هؤلاء يمكن أن يشكلوا أعدادًا معتبرة في كل بقاع الأرض، وإذا أضفنا إليهم أعداد الرافضين لتلقِّي اللقاحات بسبب الخوف أو اعتناق نظرية المؤامرة، وقد أظهر مسح "جالوب" الصادر في العشرين من شهر نوفمبر 2020 أنهم يشكلون نسبة 42% من البالغين في الولايات المتحدة،
وهكذا نكون إزاء ملايين ينتشرون في كل بقاع الأرض، من الممنوعين قسرًا، والممتنعين بإرادتهم عن تناول اللقاحات الموعودة، أي ملايين المعرَّضين للإصابة بالفيروس والناقلين للمرض! فعلامَ الانتشاء؟!
ثلاث سلالات جديدة وموجة ثالثة
حتى كتابة هذه السطور، وفي خضم موجة ثالثة من الإصابات بكورونا أسرع انتشارًا واجتراءً على فئات كانت مستبعدةً من استهداف الموجة الأولى والثانية، كالأطفال، ومع بدء توزيع اللقاحات الشهيرة المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي أظهر بُطئًا ومحدوديةَ نطاق على غير أحلام مَن تولتهم النشوة بالعثورعلى إكسير في متناول اليد يُنهي الجائحة،
ظهرت ثلاث سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، واحدة ببريطانيا، والثانية بجنوب إفريقيا، والثالثة باليابان، والحبل على الجرَّار!
هذه "السلالات الجديدة" من الفيروس، أثارت سؤالين كبيرين -ضمن أسئلة أخرى- تتعلق بطبيعة الفيروس وصلاحية اللقاحات البازغة لمواجهتها، من أين جاءت؟ وإلى أين تسير؟ والإجابة عن السؤال الأول نجدها عند رافيندرا جوبتا، عالِم الفيروسات بجامعة كامبريدج،
عن مريض بالسرطان جاء إلى مستشفى محلي في شهر مايو 2020 مصابًا بـCOVID-19 وظل يفرز الفيروس، كان يعالج من سرطان الغدد الليمفاوية الذي انتكس ويتناول دواءً يستنفد الخلايا البائية المنتجة للأجسام المضادة، فلم يستطع التخلص من العدوى بفيروس سارس-كوف-2،
وظل "جوبتا" -الذي يدرس كيفية ظهور مقاومة لعقاقير فيروس نقص المناعة البشرية- مهتمًّا بالحالة وساعد في تطبيب المريض الذي توفي في أغسطس الماضي، بعد 101 يوم من تشخيص إصابته بكوفيد-19 وتناوله عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات وجولتين من بلازما المتعافين من كورونا المحتوية على أجسام مضادة للفيروس،
وعندما درس "جوبتا" تسلسل جينوم الفيروس الذي أصاب المريض، اكتشف أن سارس-كوف-2 قد اكتسب العديد من الطفرات التي ربما سمحت له بتجنُّب الأجسام المضادة، وهكذا توافرت معلومة أولية للباحثين الذين يحاولون فهم أهمية هذا التغيُّر، وعلاقته بظهور السلالة الجديدة من الفيروس في المملكة المتحدة، ورُجِّح أن الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة عندما يصابون بعدوى كورونا المستجد،
تتيح أجسامهم للفيروس فرصة الاستشراء دون كابح في تكاثره، ومن ثم تزيد احتمالات حدوث الطفرات وظهور سلالات الفيروس الجديدة، الأسرع في الانتشار والأوسع في تسبيب المرض، مع احتمال الهروب من اللقاحات، وهذه لا تشكل خطورةً على المرضى فحسب، بل قد يكون لها القدرة على تغيير مسار الوباء نحو الأفدح.
وفي السياق ذاته، ومع ظهور سلالتين جديدتين أُخريين من الفيروس المسبب لكوفيدـ 19 في جنوب إفريقيا، ثم مؤخرًا في اليابان، صار السؤال أكثر إلحاحًا عن إمكانيات هذه السلالات الجديدة، وما يستجد منها، في إضعاف أو إبطال مفعول اللقاحات البازغة، وعن ذلك قال شين كروتي،
من معهد "لا جولا" لعلم المناعة بالولايات المتحدة: "سيكون الأمر تحديًا حقيقيًّا للفيروس للهروب من تأثير اللقاحات التي تستهدفه، فهذا تاريخيًّا لم يحدث، وفيروسات الحصبة وشلل الأطفال لم تتعلم أبدًا الهروب من اللقاحات تستهدفها"، وهذا يمكن أن يكون مطمئنًا،
ومثله تصريح المسؤولين عن شركات وهيئات تطوير اللقاحات التي نالت تصاريح القبول بالتوزيع، وإن كانت هناك إشارات إلى أن نسبة نجاح اللقاحات ستقل –قليلًا- مع السلالات الجيدة، لكن، حتى لو كانت كل الطمأنات صادقةً ومستندةً إلى منطق علمي،
فإن مجموع الحقائق التي تضمنتها هذه السطور، نكرر: " نعم، ظهور اللقاحات المستهدِفة لفيروس كورونا المستجد تمثل ضوءًا في نهاية النفق، لكنه نفق طويل وتكتنفه أخطار وصعوبات، مما لا يسمح بالتسرُّع في الانتشاء بظهور اللقاحات الموعودة"، وهناك ما يرجح أن مفعول هذه اللقاحات لن يؤتي أُكله حتى نهاية العام 2022،
ووفقًا لدراسة نمذجة جديدة أجراها باحثون في مدرسة تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، فإنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى فترات متقطعة من التباعد الاجتماعي حتى عام 2022 لضمان أن المستشفيات لديها سعة كافية لمرضى كوفيد-19 في المستقبل الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة! فماذا نفعل؟
ماذا تبقَّى أمامنا لنفعله؟
يجيب عن ذلك السؤال عالِم الفيروسات البلجيكي، بيتر بيوت، المعروف بلقب "صائد الفيروسات" لاكتشافه فيروس إيبولا القاتل، قائلًا: "المفتاح هو أن الحكومات بحاجة إلى معرفة بؤر تفشِّي المرض في وقت مبكر- والتحرك بسرعة"، ويعطي مثالًا بمدينة أنتويرب البلجيكية،
التي نفذت على الفور حظر التجول الصيف الماضي عندما ارتفعت نسبة الحالات، وإلى دولة سنغافورة التي نفذت أوامر البقاء في المنزل عندما واجهت تحديًا مشابهًا، وأضاف تأكيدًا على هذه النقطة: "إن الأوروبيين بحاجة إلى "تغيير ثقافي" للتعامل مع الأوبئة وحالات الطوارئ في المستقبل،
ومن المهم أيضًا أن نتذكر أننا في البداية فقط، وإذا التقينا بعد عام من الآن آمل أن نكون جميعًا قد جرى تطيعمنا وصار في إمكاننا أن نسافر"، وأكد أنه "حتى عندما نحصل على حقنة اللقاح، فإن اللقاحات الأولى لن تكون الأكثر فاعلية، لهذا فإن الناس أحوج للوصول إلى "تغيير ثقافي" للتعايش مع الفيروس،
وهذا يشمل عدم المصافحة واتباع الممارسات الآسيوية القديمة في ارتداء الكمامة، ليس لحماية أنفسهم، ولكن لحماية المجتمع، هذا هو نوع التغيير الثقافي الذي نحتاجه في أوروبا".